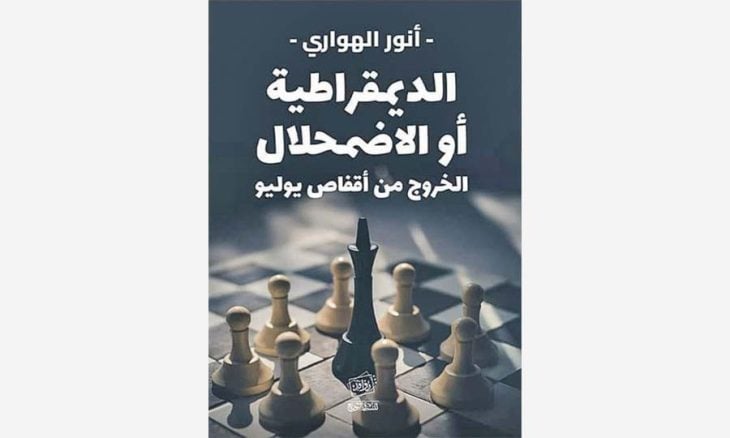
الكاتب والصحافي أنور الهواري لا يحتاج شهادة علي تاريخه الصحافي وكتاباته الفارقة. قدم لنا في العام السابق كتابين من أهم الكتب الفكرية والسياسية هما «ترويض الاستبداد» و»الديكتاتورية الجديدة». أنفقت مع الكتابين السابقين وقتا رائعا كما تعودت من زمن قديم مع كتاباته، وكتبت عن كل منهما مقالا، وها أنذا أجد له كتابين في معرض القاهرة الدولي الأخير للكتاب، منشورين عن دار «روافد» التي نشرت كتابيه السابقين أيضا.
الكتابان الجديدان هما «في انتظار الحرية» و»الديموقراطية أو الاضمحلال – الخروج من أقفاص يوليو». دون قصد اخترت هذا الكتاب الذي اكتب عنه الآن، فمعرفتي بكتابات أنور الهوراي لا تجعلنى أقدم كتابا على آخر، لكن اندفع بشغف إلى القراءة مدركا أني سأدخل عالما شجاعا مليئا بالأفكار الجديدة، ودليلا علميا وبحثا تاريخيا يؤكد رؤيته لما يكتب عنه.
ربما بدأت بهذا الكتاب لأن موضوع الديموقراطية وثورة يوليو شغلني طول حياتي. كان خلفية لكثير من رواياتي، وكتبت عنه مقالات، وآخر ما كتبت منذ عام كتاب صغير هو «البيان الأخير ضد فيلم أحب الغلط» لكني مع أنور الهواري أعرف أني سأدخل من أبواب التاريخ بشكل أكثر تفصيلا، لا تنفصل فيه مصر عن العالم، فتتوسع الرؤية والمعرفة، وتكون الرحلة نقشا على بردية الزمن، مغرية الشكل والمضمون في شجاعتها الفارقة.
عبر الكتاب يقدم تاريخ الثورة والدولة، وتاريخ الانقلابات العسكرية في العالم كما يراها، ورآها فلاسفة ومفكرون مثل صمويل هنتجتون وغيره. كيف يستولي العسكريون غالبا على السلطة من أنظمة ملكية تحللت، أو من أنظمة ليبرالية تعفنت، أو من حكم أقليات مميزة طبقيا، وكلها نظم تعجز عن الاستمرار، لأنها عجزت عن تطوير مؤسسات سياسية تستوعب الطبقات الوسطى الناشئة، الراغبة في المشاركة في السلطة والثروة، فيأتي العسكريون بالإنابة عنها كرسل للنظام والاستقرار والقانون وتماسك الدولة وسلامة التراب الوطني. الكتاب حافل بأراء الساسة والمفكرين من مصر والعالم، يعكس عمق الدراسة والتحليل ولن يكفيها المقال.كثيرون من المفكرين رأوا، وهم على حق، أنه مع حركة الضباط الأحرار في يوليو 1952 تم إيقاف مسيرة الليبرالية المصرية، ودخلت البلاد في حكم الفرد ولم تخرج، وكان ذلك السبب الرئيسي في نكباتها الكبري، سواء هزائم عسكرية في حروبها مثل 1956 أو 1967 وبينهما حرب اليمن، وحتي حرب أكتوبر التي كانت نصرا، ذهب بها حكم الفرد إلى اتفاقية كامب ديفيد التي لم تكن بمستوي النصر.
يقف أنور الهواري عند ذلك راجعا إلى التاريخ الحديث بل والعصور الوسطي، وكيف كان الجيش هو حامي النظم السياسية التي رفعت شعار الحداثة مع محمد علي وأبنائه، بتفاصيل كبيرة، لكنه يتوقف بتمهل كبير عند حالنا الآن تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة، كتجسيد للحكم المطلق بكل تجلياته، من مصادرة للرأي الآخر وإنهاك للأحزاب وفشل اقتصادي وسيطرة عسكرية على كل منابع الحياة ومظاهرها.
حين تأسست قبل قرنين دولة حديثة في مصر في عهد محمد على، استعارت من أوربا بعض المعارف والقوانين، لكن حافظت على مضمون الحكم العثماني المملوكي من حيث استبعاد الشعب من معادلة الحكم. لم تكن الحداثة مع الدولة الحديثة فقط، بل سبقتها، وسبقت حتى دخول نابليون إلى مصر، لكنها كانت شعارا، فالحاكم كان هو الحكم نفسه، مهملا أن الحداثة الحقيقية في الحكم والسياسة تعني أن الدولة بكل مؤسساتها وسلطاتها في خدمة المواطنين ورفاهيتهم وراحتهم، لا أن يكون المواطنون في خدمة طبقات الحكم ملوكا أو رؤساء، ومن حولهم من نبلاء أو أشراف أو طبقات مميزة أو منتفعين ومتربحين.
هناك لحظات حقق فيها الشعب ذلك مثل ثورة 1919 أو ثورة يناير لكنها أُجهضت. كانت الضربة القاسمة لإنجاز ثورة 1919 مع انقلاب يوليو 1952 وكانت الضربة القاسمة لثورة يناير مع تنازل مبارك عن الحكم للمجلس العسكري، الذي سيطر على كل مظاهر اللعبة، حتى في مجيئ الإخوان المسلمين العابر ونهايتهم طبعا. كل الحكام الديكتاتوريين منذ محمد علي عرفوا مداخل الحكم وتوقيتها، لكن لم يحدث في أي حالة أن كانت المخارج معروفة. كلهم بلا استثناء يقسمون على حفظ الدستور والحكم العادل، ثم يغيرون كل شيء لبقائهم إلى الأبد فلا خروج. يتلاعبون بالدساتير ويزورون الانتخابات وتتحقق استفتاءات زائفة ليبقوا في السلطة دون مخرج.
ما كان عليه الباشوات صار عليه الحكام من العسكريين ومن والاهم في مميزات الحكم والحياة بعد انقلاب يوليو. رغم تراجع ذلك بعد هزيمة 1967 ودعوات من قادة عسكريين لابتعاد الجيش عن السياسة، عاد الأمر مع السادات بعد حرب اكتوبر واستمر.
مقارنة بين دولة محمد علي التي كانت خروجا من الفوضي بعد رحيل الفرنسيين مع بونابرت، وكذلك الجمهورية الجديدة التي جاءت سدا لفراغ السلطة بعد 25 يناير 2011 وخروجا من الفوضى المحتملة بعد إزاحة الإخوان، وكلاهما، محمد علي والجمهورية الجديدة، ليستا دولة حداثية.
كيف استمر الطغيان وكيف يمكن أن يذهب الطاغية ويأتي آخر. طغيان عبد الناصر كان بديلا عن طغيان أسرة محمد علي واستمر مع السادات ومبارك، ثم الإخوان مع محمد مرسي الرئيس المدني بإعلانه الدستوري، وهجمة الإخوان غير الحصيفة على كل المناصب العظمي، مثل رئاسة مجلس الشعب ومجلس الشوري ورئاسة الجمهورية ورئاسة والوزراء الخ. تماما مثل من قبلهم! ثم طغيان الجمهورية الجديدة حولنا.
باستكمال الجمهورية الجديدة عشر سنوات حتى صيف هذا العام 2024 يكون حكم الضباط قد استهلك سبعين عاما، وتحتاج مصر مثلها حتى تبدأ في التعافي. ليس للجمهورية الجديدة مخرج إلا الخروج من أقفاص يوليو مرة واحدة وإلى الأبد. تفاصيل ذلك كله عبر التاريخ إلى الآن، وكيف انتهينا إلى ما سبقت الإشارة إليه من مصادرة للحريات وأزمات اقتصادية في الجمهورية الجديدة.
مقارنات بين الآن وعصر اسماعيل ووقوع مصر في قبضة الدول الدائنة التي يمثلها الآن صندوق النقد الدولي، وكيف وصلت الجمهورية الجديدة إلى انسداد كامل سياسي واقتصادي واجتماعي. كيف جاء هذا الانسداد بيديها، لا من ضغط خارجي، ولا من الربيع العربي الذي جعل الحفاظ على بقاء الدولة المصرية وسلامتها، ضرورة عملية لا خلاف عليها في الداخل أو الخارج على عكس ما يقال. جاء الانسداد بيديها حين جعلت حكم الفرد المطلق هو نموذجها السياسي، والتنمية التي يتحدثون عنها دون رؤية.
أول الأسباب أن الرئيس يرى أن الله جعله طبيبا يصف الحالة ويرى الحقيقة وحده. ثانيها أن من يسمعونه من خبراء في كل مجال لكن ينفذوا ما يقوله فقط، والشكل الثالث للانسداد الذي يغفل عنه الحكم، هو حالة عدم الرضا الاجتماعي، التي تراكمت بالتدرج مع وعود الجمهورية الجديدة، ثم إخلافها وتقديم أعذار واهية لا يصدقها الشعب ولا يقبل بها.
السؤال هو هل بات يلزمنا ثورة جديدة؟ الإجابة لا. يرى أنور الهواري ذلك، ويقدم حلولا على رأسها البناء على ثورة يناير التي لا تزال رسالتها ترن في أذن كل مصري مهتم بالشؤون العامة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وهي كافية لإعادة توجيه الدولة للمسار الوطني الصحيح، غير متأثرة بإيحاءات دولية أو اقليمية. كما يقدم نموذجا لمخرج من الحكم العسكري حدث في بلاد مثل المكسيك وتركيا التي عرفت الانقلابات حتى المحاولة الأخيرة الفاشلة عام 2016 وكوريا الجنوبية.
في المكسيك أنشأ قادة الثورة العسكرية «الحزب القومي الثوري» وصار الجيش بعد الثلاثينات من القرن الماضي بعيدا عن السياسة، كذلك فعل كمال أتاتورك. فبعد نجاح الانقلاب العسكري عام 1908 ونجاح حركة تركيا الفتاة في الاستيلاء على الحكم، بدأ أتاتورك يدعو إلى الفصل الكامل بين ما هو عسكري وما هو سياسي، علي عكس ما حدث في مصر بعد 1952. حتى نصل في الكتاب إلى هذه الأمثلة من الحلول، نكون قطعنا رحلة رائعة بين التاريخ والحاضر جديرة بكل احتفاء.
كاتب مصري










